
لقد فقد المثقفون التقليديون جُلّ امتيازاتهم السابقة التي كانت تمنحهم سلطة الهيمنة والاستحواذ على من هم دونهم اطلاعاً وتحصيلاً ووقوفاً على الحقائق، وبات محرك البحث «غوغل» شبيهاً بقمقم سحري لا يحتاج فتحه والوقوف على كنوزه المعرفية إلى أكثر من نقرة أصبع سريعة. ولا يقتصر الأمر على وجه واحد من وجوه المعرفة أو الاختصاص، بل يستطيع أي شخص عادي أن يحصل على ما يريده في مجالات التاريخ والجغرافيا والفن والفلك والطب والشعر والرياضيات وعلوم النفس والاجتماع... وغيرها، بحيث يصبح «غوغل» بشكل أو بآخر التجسيد الفعلي لفكرة خورخي بورخيس عن المكتبة الكونية التي تختزن بين جنباتها كل علوم الأرض وآدابها منذ الأزل وحتى إشعار آخر.
لا أحسب أن مارك زوكربيرغ من جهته كان يدرك في البدء أن موقع «فيسبوك» الذي دفعته إلى تأسيسه رغبته الشخصية في إقامة نوع من التواصل المباشر بينه وبين زملائه في الجامعة، سيمكنه خلال سنوات قليلة من أن يستقطب مليارات البشر الساعين إلى الخروج من عزلاتهم وقواقعهم المغلقة نحو رحابة التواصل الإنساني والتفاعل مع الآخرين.
وقد يكون إقبال البشر الكاسح على وسائل التواصل بمثابة رد رمزي على الجانب الوحشي من العولمة، خصوصا في شقيها الاقتصادي والسياسي، حيث يتم طحن الأفراد والمجموعات الأقلوية تحت سنابك الإمبراطوريات الكبرى والشركات العابرة للقارات.
وإذا كان «غوغل» وغيره من محركات البحث يوفر لزواره على اختلاف مستوياتهم متعة الاطلاع والتحصيل النظري، فإن «فيسبوك» وإخوانه يوفرون لزوارهم متعتين أساسيتين؛ تتعلق أولاهما بالمشاهدة والتلصص على حيوات الآخرين ونصوصهم وأحوالهم، فيما تنتقل الثانية إلى خانة الفعل والمشاركة المباشرة عبر الكتابة والموقف في أكبر الجداريات النصية والسيميائية التي عرفها التاريخ البشري. الـ«فيسبوك» بهذا المعنى هو نقل للعولمة من إطارها النخبوي إلى إطارها «الشعبوي» حيث بات لكل فرد، صغُر أم كبُر، حق الظهور صورةً ولغةً على شاشته الهائلة التي تتسع لجميع الوجوه؛ السافرة والمقنعة، ولجميع الأسماء؛ الحقيقي منها و«الحركي». وحيث الكل يتواصل مع الكل بلا حواجز ولا حدود، فإن هذه الشبكة العنكبوتية قد استطاعت أن تشكّل أكثر من قوة ضغط سياسية واجتماعية وأخلاقية، وأن تلعب قبل سنوات أكبر الأدوار خطورة في انتفاضات الربيع العربي وفي التحولات التي أعقبتها.
لقد حقق «فيسبوك» بامتياز رغبة البشر المهمّشين والمتوارين داخل حيواتهم المنسية في تحقيق ذواتهم وإثبات وجودهم وإعلان انتسابهم إلى هذا الكوكب الذي لا يكف سكانه عن التناسل المطرد. فقد باتت صفحاته الرحبة تتسع لجحافل لا تحصى من البسطاء والكادحين والجنود المجهولين والأطفال والعجزة وممن لا يكادون «يَفُكُّون الحرف»، وكل من يريد الدفع بأناه المغيبة والمكبوتة إلى الظهور أو التحقق عبر نشر صور وأخبار مفصلة عن مأكله ومشربه ومغامراته وحِلّه وترحاله.
وكلما ازداد شعور البعض بالعزلة والتهميش وعقد النقص ازداد بالمقابل تهالكهم على البروز وتضخيم الذات، وإلحاحهم على طلب الصداقات مع كتّاب وفنانين ونجوم لم يكونوا من قبل ليجدوا سبيلاً إلى معرفتهم أو التواصل معهم أو نشدان صداقتهم. هكذا تبدو مواقع التواصل من بعض وجوهها أشبه بـ«هايد بارك» كوني من الوجوه والأصوات والمواقف والخطب والآراء والشعارات. ويبدو حائطها المفتوح على مداه أشبه ببرج بابل جديد من خلائط اللغات والوقائع وأخبار الوفيات والولادات وحفلات الزفاف والولائم والاحتفال بالحياة أو التبرم من صروفها.
وإذا كان «غوغل» قد جعل المعرفة مشاعاً بين البشر، فإن «فيسبوك» قد انتقل بهم من مشاعية «التلقي» إلى مشاعية «الإرسال»، ومن خانة القراءة إلى خانة الكتابة والتعبير.
لكن اللافت في هذا السياق هو أن بابل الجديدة قد ألغت الفوارق بين الجميع ولم يعد ثمة من تراتبيات مسبقة في سلم التصنيفات بين المشاركين، بحيث يمكن أن يتجاور المشاهير والمغمورون، الأسماء البراقة والأسماء الغفْل، الرواد المخضرمون والمتدربون الصغار. لا بل إن «فيسبوك» قد ذهب أبعد من ذلك حين قلب هرم التراتب على رأسه وخلط أوراق اللاعبين وفقاً لمعايير وأسس مغايرة لا ينتمي معظمها إلى المعايير النقدية الموضوعية، بل إلى معايير المجاملات الاجتماعية والمداهنة والتزلف المتبادل. يكفي أن نتصفح حائط الشبكة العنكبوتية بشكل عشوائي لكي نتوقف ذاهلين إزاء التفاوت الواسع بين العدد الضئيل لعلامات الإعجاب التي تُمنح لكاتب مرموق، وبين مئات «اللايكات» التي تحصل عليها كاتبة رديئة تدعو المفتونين بجمالها إلى مشاركتها فطور الصباح. ولعل هذا الوضع الغرائبي بامتياز هو ما دفع كاتباً عالمياً مرموقاً هو الإيطالي أمبرتو إيكو إلى شن هجوم بالغ القسوة على مواقع التواصل، لأنها، وفق تعبيره، نوع من «غزو البلهاء»، ولأنها «تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى ممن كانوا يثرثرون في الحانات فقط دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما الآن فلهم الحق في الكلام كمن يحمل جائزة نوبل».
لقد تحولت ساحة «فيسبوك» إلى مباهلة لغوية غير مسبوقة بين ملايين المنتسبين إليه ممن يقدّمون دون انقطاع تعليقات ونصوصاً مفتوحة حول شؤون الحياة وشجونها المختلفة. ولأن الشعر، في الإطار العربي، لا يزال يحتفظ بوهجه ورمزيته العالية، فإن آلافاً مؤلفة من غير الموهوبين ومنتحلي الصفة قد وجدوا الفرصة سانحة لوضع ما يكتبونه ضمن خانته، ولادعائهم، كهولاً ومسنين، اللقب الذي لم يكونوا ليجرؤوا على ادعائه في مطالع شبابهم. لقد أفاد هؤلاء من حالة البلبلة وسوء الفهم المتعلق بالحداثة الشعرية، وبقصيدة النثر على وجه الخصوص، ليدرجوا كل ما يرتجلونه من «تأوهات» وخواطر إنشائية ساذجة ضمن خانة الشعر وإطاره.
على أن الأمر لم يتوقف عند حدود الشعرية «الافتراضية»؛ بل انتقل فجأة إلى التكريس المباشر على أرض الواقع من خلال عقد الأمسيات والمهرجانات المتنقلة، وصولاً إلى إصدار النصوص في مجموعات ودواوين مستقلة، يفيد كتابها من فوضى النشر وغياب النقد على حد سواء. وقد يكون «فيسبوك» قد عزز بشكل أو بآخر فكرة الرمزيين الذين يرون في كل شخص شاعراً بالقوة، لكنه يحتاج لكي يصبح شاعراً بالفعل إلى الموهبة المجردة؛ بل إلى سنوات كاملة من الكدح والمثابرة وتنمية قدراته الأسلوبية والجمالية. لكن النسبة العظمى من الأسماء المعنية بالأمر تفتقر إلى الموهبة من جهة وإلى الاشتغال والحفر المعرفي من جهة أخرى.
على أن الوجه الآخر للصورة يتمثل في تحول مواقع التواصل إلى محفزات دائمة للتفنن الأسلوبي وتمرين الخيال على الابتكار، ولتفجير كل ما كان البشر الموهوبون يختزنونه في أعماقهم بفعل التهيب والخوف. كما يتمثل في اكتشافنا اليومي لمزيد من الأسماء المفاجئة التي لا تكف نصوصها الشعرية والنثرية عن إصابتنا بالدهشة أو الذهول. ثمة أسماء كثيرة لم يسبق أن سمعنا بها من قبل تمكنت خلال فترة وجيزة من رفد شعريتنا العربية الآخذة في الترهل بقدر هائل من الاستعارات الطازجة والكشوف الجمالية غير المألوفة. صحيح أن منسوب التسيب الذي أتاحته مواقع التواصل قد بلغ مستويات غير مسبوقة، ولكن الصحيح أيضاً أن الجودة تكتسب ألقها الإضافي في ظل هيمنة الرداءة والتهافت الغث. والذهب وسط أكوام الرمال يبدو أكثر إثارة للفتنة منه في محلات الصاغة وواجهات العرض.
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

 الرائحة..!!
الرائحة..!! مدينة سيئون تشهد فعالية مهرجان "ألحان الزمن الجميل" للمايستروا محمود الهندي بعرض تسع مقطوعات تراثية
مدينة سيئون تشهد فعالية مهرجان "ألحان الزمن الجميل" للمايستروا محمود الهندي بعرض تسع مقطوعات تراثية  تحت شعار: "مشروع المستقبل برؤية أنثوية" .. الأوديسة الأوروبية تقيم ندوة في الألياذه لعدد من المهتمين بأحداث الاوديسا
تحت شعار: "مشروع المستقبل برؤية أنثوية" .. الأوديسة الأوروبية تقيم ندوة في الألياذه لعدد من المهتمين بأحداث الاوديسا الكتابة في الضوء .. كلمات الأمل والصمود
الكتابة في الضوء .. كلمات الأمل والصمود  قصيدة: للإِظلامِ آجالُ
قصيدة: للإِظلامِ آجالُ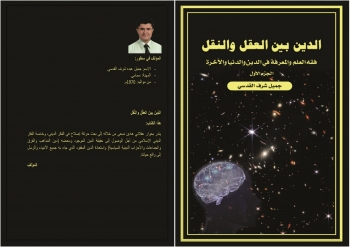 صدر حديثاً عن «مكتبة خالد بن الوليد - صنعاء» .. «الدين بين العقل والنقل» كتاب جديد للباحث والمؤلف المحامي: جميل شرف القدسي
صدر حديثاً عن «مكتبة خالد بن الوليد - صنعاء» .. «الدين بين العقل والنقل» كتاب جديد للباحث والمؤلف المحامي: جميل شرف القدسي
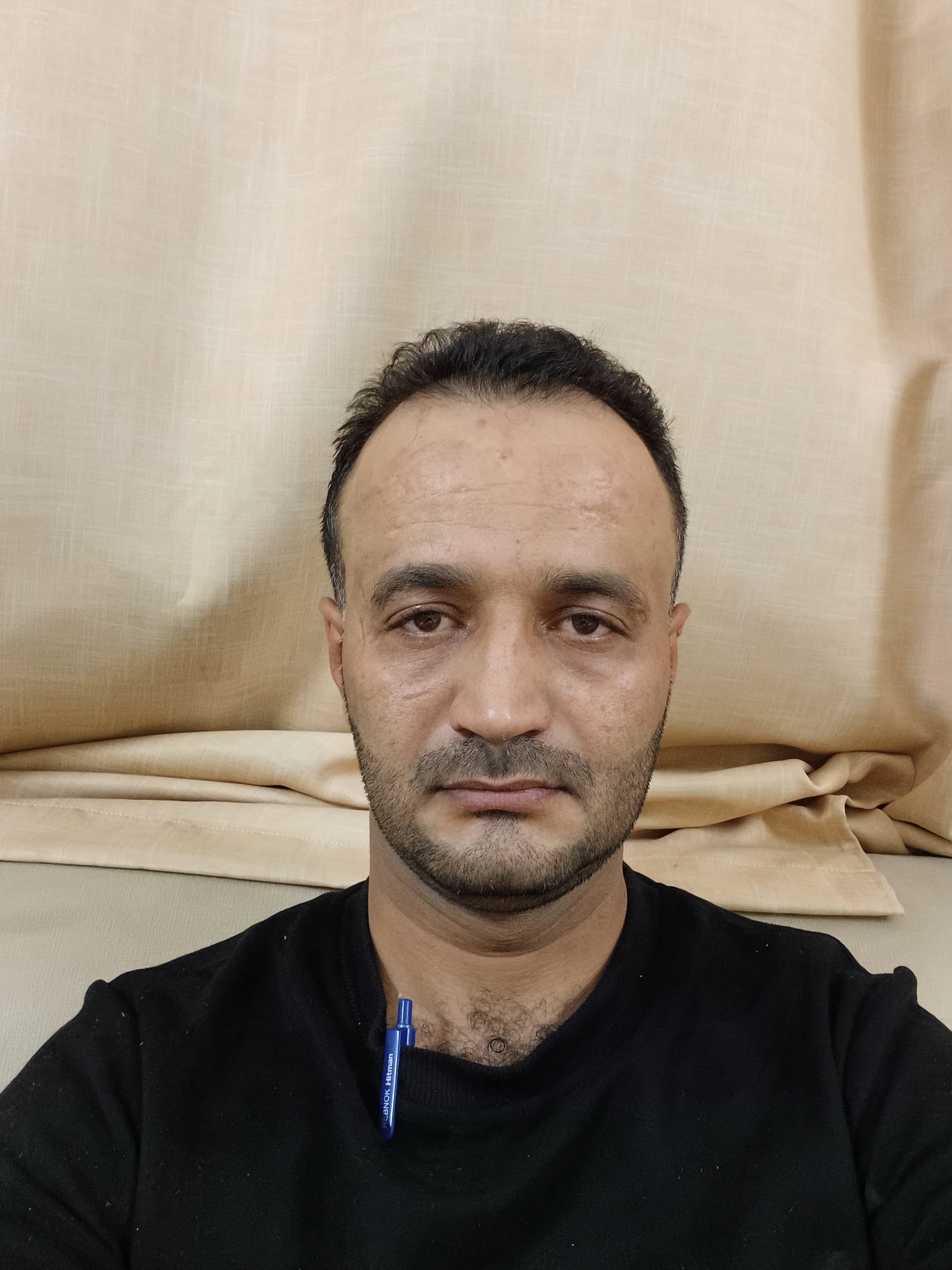






 رئيس الوزراء «سالم بن بريك» يشعل الدبلوماسية اليمنية في أسبوعه الثاني «تقرير»
رئيس الوزراء «سالم بن بريك» يشعل الدبلوماسية اليمنية في أسبوعه الثاني «تقرير»  رئيس الوزراء: خطة الحكومة المقدمة للاجتماع الوزاري الدولي قوبلت بدعم كبير وتم الاتفاق على آلية دعم مباشر لها
رئيس الوزراء: خطة الحكومة المقدمة للاجتماع الوزاري الدولي قوبلت بدعم كبير وتم الاتفاق على آلية دعم مباشر لها  نشاط دبلوماسي واسع وفعاليات دولية مثمرة.. الاول مرة دعم دولي مطلق لليمن «تفاصيل»
نشاط دبلوماسي واسع وفعاليات دولية مثمرة.. الاول مرة دعم دولي مطلق لليمن «تفاصيل» 